بقلم: ألفة السلامي
قالت وهي قلقة ومتوترة إنها قد لا تقدم على الحمل أبداً بعدما ناقشت ذلك مع زوجها الذي حذرها من مغبة أن تخسره إذا أقدمت على هذا القرار بالسعي للإنجاب من جانب واحد! لا أدري كيف تسعى للإنجاب من جانب واحد. تساءلتُ داخليا واكتفيت بالضحك والإنصات؛ كان المقصود بالطبع أنه يريد علاقة زوجية حميمة بدون حمل أو إنجاب أطفال. كنت قد سمعت هذه الأفكار كثيرا جدا بين أبناء جيلي، في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، عندما كنت في الجامعة وفي بداية سنوات العمل.
لكن تخيلتُ أن جيلي "دقة قديمة بأفكاره وتصوراته" المتطرفة. كانت أفكارنا توصف من بعض أساتذتنا اليساريين بـ "التقدمية"، بينما يصفها آباؤنا وأجدادنا بالأنانية المفرطة لمجرد تفكيرنا في التركيز على مستقبلنا المهني وصقل مهاراتنا وتحقيق طموحاتنا الاقتصادية والاجتماعية، أولاً وقبل أي أهداف أخرى تأتي لاحقا.
كانت باقة من الأحلام نراها مشروعة وعادية وليست غريبة كما يصفها جيل يكبرنا، تقدر قيمة التعليم والعمل والخبرة المكتسبة من خلال الاحتكاك بالشارع بمعناه الواسع كفئات مختلفة وأنماط متعددة. ثم يأتي بعد ذلك حلم تكوين أسرة صغيرة أو ربما صغيرة جدا لا تتجاوز ثلاث أو أربع أفراد. عاش أغلبنا داخل عائلات ممتدة كثيرة العدد وامتلأنا بالمشاعر والذكريات، وحلمنا بالأسرة الصغيرة كنقيض ما عشناه ولم تكن لدينا حينئذ خبرة معايشة كيف يكون الإنسان عندما يتخلى عن "فيتامينات ومعادن" هذا الزاد العاطفي من العائلة الكبيرة!
كان أبناء جيلي يقولون مازحين إن إنجاب طفل واحد "قليل" وإنجاب طفلين "كثير"، فنضحك مقدرين ما تتضمنه هذه الأفكار من تحمل المسؤولية لكي يتربى الأبناء في ظروف أفضل من ظروفنا، حيث كنا نتوق أن يكون أبناؤنا أفضل منا. لم تكن الظروف تعني بالنسبة لنا الجوانب المادية فقط بل قيمة الوقت وجودته أيضا بما يسمح بمواصلة العمل وبناء علاقات صحية مع الأبناء تتضمن التربية والسلوك والتعليم وكذلك الترفيه لتكوين ذكريات مشتركة تكون زاداً لهم أيضا ولنا عندما يستقلون بحياتهم. لكن اكتشاف وجود هذه الأفكار مجددًا والمقتنعة بعدم الإنجاب، أو الاكتفاء بطفل واحد، كان مفاجأة، رغم كونها محصورة بين الفئات من المتعلمين تعليمًا جيدا والحاصلين على وظائف بارزة مثل صديقتي وزوجها وأصدقائهما. وكنت قد اقتنعت بأنها اختفت وموجودة فقط في المجتمعات الغربية، لكن يبدو أنها عادت إلينا أيضا.
صديقتي الشابة هي من جيل الألفية الثانية أي الجيل الذي ولد في نهاية التسعينات، وقد نشأت في بيئة حرّكتها هذه الفكرة الجوهرية. وعندما كانت في نهاية مرحلة الطفولة وبداية شبابها كان المجتمع والإعلام والعالم كله منشغلا بإرهاصات ما بعد الربيع العربي، وغاب العلماء والمفكرون والتربويون عن البرامج ووسائل الإعلام وضيوف الأنشطة الطلابية وانتفى تقريبا دورهم، بالتالي تأثيرهم على الأجيال الشابة، حيث كان أبطال البرامج والأنشطة الدعاة ونجوم الرياضة والفن، و"الطباخون" في الطعام والسياسة على حد السواء.
كما ظهرت تدريجيا خطابات العلاج النفسي الموجهة للأمهات إلى البرامج التلفزيونية التي يشاهدها الكثيرون، والكتب التي يقرؤونها "سماعا" وليس قراءة، وهي ليست سيئة في أهدافها التوعوية لكنها كانت توجها شكليا، يعني مجرد "تراند" من الترندات، وتُصور كأنها المنقذ الذي يمكن الاتكال عليه لإيجاد الحلول وليس لصناعتها. ومصدرها الأصلي قادم من البرامج الحوارية الأجنبية التي يتابع الشباب مقاطع منها على شبكات التواصل الاجتماعي، مثل أوبرا وينفري والدكتور فيل واللذين اشتهرا بطرح آراء حول مواضيع اجتماعية، مثل "الأمهات الخارجات عن السيطرة" وصدمات الطفولة والتعديل السلوكي، وصولاً إلى حلول محافظة مثل أن الأمهات مكانهن البيوت وتربية الأبناء، خاصة بعد أن تصدرت المربيات مجال التربية، وأخذن مكانة الأمهات.
ثم ظهر المحتوى العلاجي النفسي في المدونات الصوتية، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وفي النوادي وبعض المدارس الخاصة والأجنبية. مع مرور الوقت، استوعب الكثير من أبناء جيل ما بعد الثورات والجوائح، خاصة من مثقفي الطبقة الوسطى والعليا، النظرية القائلة بأن الهوية وأسباب المعاناة تتحدد إلى حد كبير مع كيفية التربية، وأن الإخفاقات ومشاكل العلاقات وعدم القدرة على وضع الحدود يمكن إرجاعها إلى الآباء، وخاصة الأمهات. ولا ينبغي أن يكون مفاجئًا إذن أن الأمومة بالنسبة للعديد من النساء أصبحت مليئة بالقلق والشعور بالذنب.
تتابع صديقتي الحديث عن مشاعرها المرتبكة: "استطعت أن أقنع زوجي بالطفل الأول وهو استجاب، وغالبا فعل ذلك تحت إلحاح والديه. ولكن المشكلة الآن، مع اقترابي من الأمومة وما يصاحبها من غموض، شعوري بالخوف وكأن مستقبلي بأكمله معلق في الهواء: كيف قد تتغير شخصيتي؟ كيف سيكون طفلي؟ كيف سيتغير زواجي ووقت فراغي في خضم هذا الغموض". وتضيف: "تُخبر ثقافة العلاج النفسي الأمهات ببعض التوجيهات: (يمكنكِ ضمان أن يكبر طفلكِ سعيدًا وصحيًا إذا...)؛ ثم تُقدم دليلًا إرشاديًا مليئًا بالنصائح للقراءة والتفاصيل التي تستحق الاهتمام. في مجتمعات لا تتمتع فيها الأمهات سوى بالقليل من الدعم -حيث تآكلت مساندة العائلة والمجتمع، وإجازة الأمومة ضئيلة، وتكاليف رعاية الأطفال باهظة-فإن الوعد بأن الوالدين وحدهما قادران على جلب كل الاستقرار الذي قد يحتاجه طفلهما قد يبدو أشبه بعناق دافئ. لكن في الحقيقة، هذا الوعد قد يكون فخًا".
شعرت حينئذ بضرورة التدخل للتوضيح، وقلت: "لا أجادل في أنه لا ينبغي للأمهات العمل على صحتهن النفسية، أو التفكير بعمق في أسلوبهن في تربية الأبناء، بل أخشى أن تدفع ثقافة العلاج النفسي الأمهات إلى الانشغال المفرط وغير الصحي بالنفس، وتصرف الانتباه عن العوامل الخارجية (الثقافية والاقتصادية والسياسية) التي تُشكل في الواقع مصدر هذا الكم الهائل من القلق. عندما تسعى الأمهات وراء الكمال النفسي، نادرًا ما تكون النتيجة هي السعادة أو أي مظهر من مظاهر الصحة النفسية. بل تُترك الكثيرات مع شعورٍ مُزعج بأنهن، مهما بذلن من جهد، من المُرجح أن يُقصّرن، وهي نتيجة لا تُفيد الآباء ولا الأبناء. كفى من الشعور بالذنب لدى الأمهات!
ردت صديقتي بأنها امتلأت شكوكا بعد الحوار مع زوجها وأصدقائهما أيضا وأصبحت ممزقة بين رغبة الأمومة والإشفاق على "البني آدم" القادم حتى قبل أن يصبح نطفة! ماذا تفعل وهي مازالت حتى مترددة في الإجابة على سؤال هل ترضعه طبيعيا أم بالببرونة حتى لا يتعود عليها، وهي مسؤولة الموارد البشرية في الشركة العالمية التي تعمل فيها. بعد عدة شهور قد أصبح أمًا!
عند التعمق فيما ذكرته صديقتي، فكرت في جميع الأمهات اللواتي أعرفهن، أولئك اللواتي بالكاد يستطعن التماسك بعد يوم طويل، يصرخن على أطفالهن الصغار ويندمن على ذلك فورًا؛ وأولئك اللواتي يعملن لساعات متأخرة في المكتب، بعد وقت طويل من موعد نوم أطفالهن. فكرت في نفسي، عندما كنت أحتضن رضيعي في حالة ذهول ما بعد الولادة، أحاول أن أقرر بين إرضاعه طبيعيا أو بالزجاجة وتدريبه على النوم بصحبتها وليس بصحبتي وفي حضني. لكني أدركت مع الوقت والخبرة أن الأمومة ليست مجرد رعاية وإطعام في عدد من الساعات أو الأيام، بل هي جودة الوقت لرعاية وتربية مواطنين صالحين بعين يقظة من خلال سلسلة من التدخلات المختلفة التي يمكن أن تبني مستقبل الطفل أو تدمره.
قد تكون العلوم النفسية الحديثة أقنعت بنصائحها التقليدية أجيالًا من الأمهات بأن أصغر زلاتهن قد تؤثر سلبًا على أطفالهن مدى الحياة. لكن نصائح الأبوة والأمومة لا ينبغي أن ترتكن إلى لحظة أو لحظات مرجعية بل على خلق نمط سلوكي ثنائي يتبعه الأطفال تلقائيا مدى الحياة، والأهم فيه هي القدوة المرجعية والتي تتكون من الأب والأم معا، حيث يحاكي أطفالهما في الصغر سلوكهما كالببغاء. لذلك لابد أن يكون هناك حرص مشترك على أقل ما يمكن من الأخطاء. ولعل التخلص من مشاعر الأمومة المليئة بالقلق أمر جوهري لتقليل الأخطاء!













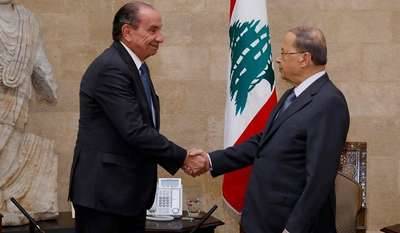

 09/17/2025 - 18:28 PM
09/17/2025 - 18:28 PM





Comments